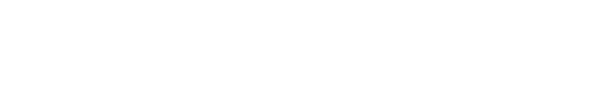هل يولد المنافق منافقًا؟!
هل يولد المنافق منافقًا؟! هل المنافق هو شخص قرر ذات يومٍ أنه سيكون كذلك؟! هل المنافق دومًا شخصٌ متآمرٌ كثيفُ الحاجبين مخيفُ الهيئةِ يجلسُ في الظلِ مع رفقاءِ دربه وزملائه في تنظيم النفاق العالمي ليضعوا الخطط التي يؤذون بها المؤمنين؟! هل يشترط أصلًا أن يعلم المنافق أنه منافق؟!
هذه الأسئلة وما كان على شاكلتها إذا أُجيبت بشكلٍ صحيحٍ ومباشرٍ قد تغير من تلك الصورة النمطية التي تجعل البعض دومًا في حالةٍ من الشعور المريح بالأمن من النفاق وفي الوقت نفسه تجعلهم على درجة من درجات السذاجة في تصورهم عن طبيعة الصراع بين الإيمان والنفاق؛ ذلك الصراع الذي يعد ميدانه الأهم نفس كلٍ منا.
والإجابة البسيطة المباشرة عن كل تلك الأسئلة التي سبقت: لا! لا يشترط شيء من ذلك كله. لا يُشترط أن ينتبه المرء فجأة من رقدته ليجد نفسه قد صار بين عشية وضحاها منافقًا خالصًا. ولا يفترض أيضًا بكل منافق فاحش النفاق أنه كان كذلك منذ البداية. بلا شك سيوجد دومًا من نافق ابتداءً لغرضٍ في نفسه التي لم تخالطها بشاشة الإيمان قط. لكن هذا ليس الأصل؛ فثمة نفاق آخر، نفاق كسبي؛ منحدر طويل قد يحتاج المرء لأعوام لكي يبلغ قعره، والمنافق هو صاحب قرار التدحرج فيه ابتداءً؛ {وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ} [الحديد:14].
ها هو أول المنحدر يبدو جليًا لكل من يريد الحذر: فتنة، ثم تربُص، ثم ريبة، ثم قعر من الاغترار والغرور، والعامل المشترك بين كل ذلك (هُم)؛ هُم من اختاروا أولا، وهُم من قرروا، وهُم من فتنوا أنفسهم، وهُم من تربصوا وارتابوا، ووهُم من غرتهم الأماني والتهمتهم أنياب الدنيا ليرفضوا النور وليوصدوا كل السبل التي قد يصل إليهم من خلالها. لكن لكل شيء بداية، وهم من اختاروا تلك البداية.
وقد تكون هذه البداية المؤدية السقوط في منحدر النفاق مجرد غفلة عابرة؛ بعض التقصير المحدود أو بوادر قسوة قلبية تم تجاهلها أو الاستخفاف بها.
(نافق حنظلةُ)؛ كان هذا هو وصف تلك الحالة والذي اختاره الصحابي حنظلة بن عامر رضي الله عنه ليعبر به عن ذلك التغير الذي لمسه في قلبه. تعجب سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه حين سمع ذلك التشخيص من حنظلة فرد قائلًا: “سبحان اللهِ! ما تقول؟” فكانت الإجابة معبرة بدقة عن تلك الأعراض التي وصل حنظلة من خلال ملاحظتها لهذا التشخيص: “نكون عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُذكِّرنا بالنار والجنةِ حتى كأنا رأيَ عَينٍ، فإذا خرجنا من عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، عافَسْنا الأزواجَ والأولادَ والضَّيعاتِ فنسِينا كثيرًا”(مسلم:2750).
يتحدث هنا حنظلة عن تفاوت؛ وعن تغير وتباين في حال القلب عند معاملة الدنيا ومفراداتها، وعن غفلة عارضة ونسيان عابر. قال الصديق أبو بكرٍ: “فواللهِ إنا لنلقى مثل هذا”، وهذا اعترافٌ صادقٌ من صاحبِ رسول الله وخليفته وأحد أقرب الخلق إليه. (إنا لنلقى مثل هذا)، وما من مؤمن إلا ويلقى مثل هذا، لكن الفارق بين هؤلاء الكرام ممن ثبتهم الله على الحق وبين من سلك منحدر النفاق حتى دركه الأسفل أن الثابتين لم يتجاهلوا ولم يستسلموا لما طرأ عليهم؛ لقد التمسا العلاج وحاولا تبين صحة التشخيص وكان ذلك من خلال المسارعة لطلبه ممن يستطيعه؛ من النبي صلى الله عليه وسلم.
انطلق الصديق وحنظلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن ذلك التغير والتفاوت الذي لاحظاه فكانت الإجابة: «والذي نفسي بيده! إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذِّكر، لصافحتْكم الملائكةُ على فُرشِكم وفي طرقِكم ولكن، يا حنظلةُ! ساعةٌ وساعةٌ، ساعةٌ وساعةٌ، ساعةٌ وساعةٌ» (مسلم:2750). هكذا كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا لتستقر في الأذهان ولتُفهم عنه وتُؤثر. إن ظل الأمر على ذلك فلا بأس، لكن الخطر كل الخطر أن تطغى ساعة الدنيا ومشاغلها وشهواتها وهمومها على الساعة الأخرى؛ ساعة القلب الحقيقية.
حين يحدث ذلك تدريجيًا تبدأ شعلة الهمة في التخافت حتى تخبو وتنهمر كتل الران على القلب حتى تصنع جدارًا سميكًا صلبًا يحول بين المرء وقلبه. عندئذ يصير الكسل عن الطاعة هو الأصل بينما تصبح المسارعة إلى غيرها هي السمة والحال. العبادات والقربات تتحول تدريجيًا إلى عادات تخلو من الروح وتثقل جدًا مع الوقت حتى تنتزع منها أهم خواصها وتصير مجرد حركات وترانيم بلا حياة ثم ربما تترك بالكلية في نهاية الأمر، وحتى إن تم أداؤها فإنه يكون أداء لواجبٍ ثقيلٍ بلا أي روح، يكون أداء لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لكنها صلاة مختلفة؛ صلاة المنافق: «تلكَ صلاةُ المُنافقِ، تِلكَ صلاةُالمُنافقِ، تِلكَ صلاةُ المُنافقِ». هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا. ثم وصف تلك الصلاة التي نسبها للمنافق قائلا: «يجلِسُ يرقب الشَّمسَ، حتَّى إذا كانت بينَ قرني الشَّيطانِ، قامَ فنقر أربعًا لا يذكرُ اللَّهَ فيها إلَّا قليلًا» (مسلم:622).
هذه إذن صلاة المنافقين؛ مجرد نقر كنقر الديكة لا يفقهون شيئًا من معانيه ولا يطرق أبواب قلوبهم الموصدة، إنهم ببساطة لا يصلون صلاة حقيقية ولكنهم كما بينت الآية: {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء:142]. ومن قبل ذلك في الآية نفسها ستجد التكاسل والتباطؤ: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ} [النساء:142]. وفي آية أخرى ستجد الاستثناء المنفي الذي يفيد القصر والحصر يبين لك أنها الصفة الرئيسية لصلاتهم: {ولَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ} [التوبة:54].
كسل رهيب، تثاقل وتماوت، ثم يعقبه الترك، قد يكون تركًا للصلاة بالكلية، وقد يكون تركًا لشيء من خصائصها كشهود جماعتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس صلاةٌ أثقَلَ على المُنافِقين من الفَجرِ والعِشاءِ، ولو يَعلمون ما فيهما لأتَوهُما ولو حَبوًا» (صحيح البخاري:657).
ويقول سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: “كنَّا إذا فقَدْنا الإنسانَ في صلاةِ الصُّبحِ والعِشاءِ أسَأْنا به الظَّنَّ” يقصد النفاق. وعن صلاة الجماعة أيضًا يتحدث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول: “ولقد رأيتُنا وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ، معلومُ النفاقِ”. هذا عن نظرتهم لتارك الجماعة، فكيف بتارك الصلاة نفسها؟!
ولا يمتنع المنافق عن الصلاة أو يتكاسل عنها وحسب، بل ستجد تكاسله أيضًا وتباعده عن سائر الطاعات خصوصًا تلك التي تستلزم بذلًا وتضحية ومن أوضحها الإنفاق: {وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} [التوبة:54]. من جديد يبرز القصر والحصر واضحًا في الاستثناء المنفي؛ إنهم إن حدث وأنفقوا مضطرين فلا يكون ذلك إلا على مضض وبكل عنت وتأفف؛ لا يطيقون العطاء ولا يحبون البذل وما ذلك إلا لسبيبن رئيسين: قلة الدافع، وقوة الصارف. أما قلة الدافع فأصلها تلك الغفلة التي استسلموا لها والنسيان الذي استمرأوه؛ قال الله عنهم: {وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة:67].
إن أعظم الدوافع التي تعين الإنسان على الطاعة وتوجهه إليها معرفة الله وذكر صفاته وتأمل نعمه وآلائه والرغبة فيما عنده عاجلًا وآجلًا. والمنافقون كما أوضحت الآية ينسون كل ذلك، بل يتناسوه، ولقد تقدم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلًا. من هنا يقل الدافع ويكاد ينعدم، ومن هنا يكون قبض اليد والشح الذي يميزهم: أَ {شِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} [اﻷحزاب:19].
السبب الثاني لامتناعهم عن الإقدام على الخير هو قوة الصارف. ويتمثل ذلك الصارف في كلمة واحدة (الدنيا). المنافق لا يرى إلا الدنيا ولا يريد إلا العاجلة ولا يبصر إلا تحت قدميه. والإنفاق والإقدام على أي خير والبذل والعطاء كل ذلك ظاهره في حسابات الماديين المتعجلين نقص في الدنيا. والمنافق لا يطيق ذلك في حق حبيبته الوحيدة وعشقه الأعظم (دنياه)؛ فمرجواته فيها، ومحبوباته تملؤها، ومخاوفه منتهاها إليها، وماله وجاهه ومنصبه وولده وشهوته وراحته وأسرته، كل شيء له محله هنا؛ في الدنيا وحدها. لذا كان صارفه عن العمل والبذل قويًا قادرًا على منعه عن أي خيرٍ يُقبل عليه. ولذا ربط حنظلة في الحديث المتقدم بين تلك الغفلة التي لاحظها في نفسه وبين مخالطة الدنيا ومفرداتها من مال أو زوجة أو ولد فقال: “فإذا خرجنا من عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عافَسْنا الأزواجَ والأولادَ والضَّيعاتِ فنسِينا كثيرًا”. هذا الارتباط بين مفردات الدنيا وشهواتها ومحبوباتها ومرجواتها ومخاوفها وبين الغفلة والنسيان المؤدي بعد ذلك للسقوط في منحدر النفاق ينبغي أن يكون دومًا ماثلًا أمام الأعين الحريصة على نجاة أصحابها.
لا ليعادوا تلك الدنيا ومفرداتها بإطلاق، ولكن فقط ليحذروا وينتبهوا وليعلموا أن من تلك المفردات ما لو تم التغافل عنه لصار حرفيًا عدوًا مهلكًا؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [التغابن:14، 15]. من هنا تظهر الحكمة في تلك الخاتمة التي اختارها الله سبحانه لتكون التوجيهات الأخيرة في السورة التي حملت اسم المنافقين (سورة المنافقون): {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [المنافقون:9].
ها هنا بيان للصارف وللدافع. أما الصارف فالإلهاء بالأموال والأولاد، وأما الدافع فهو ذكر الله.
فكأن الرسالة الختامية بعد بيان صفات المنافقين في السورة وأهم أقوالهم وأفعالهم كيفية الابتعاد عن هذا المصير.
ببساطة ألا تصرفكم الصوارف عن دوافع العمل؛ ألا تلهكم الدنيا عن الذكر وألا تنسيكم الشواغل ربكم وما عنده، وألا تغفلوا عن النهاية؛ عن الموت وما بعده؛ {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المنافقون:10، 11].
هكذا ختمت السورة بالتذكير بالموت والأجل الذي لا يؤخر، وبالتذكير بالله الخبير بما نعمل. وهذا العمل هو الحاجز الذي يحول بين المرء وبين السقوط في ذلك المنحدر البشع؛ منحدر النفاق!
بقلم/ محمد علي يوسف